


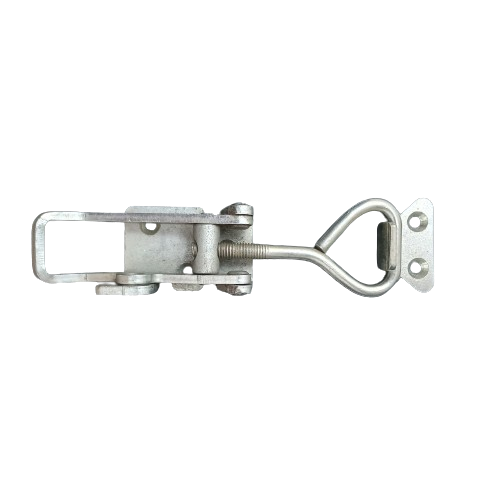



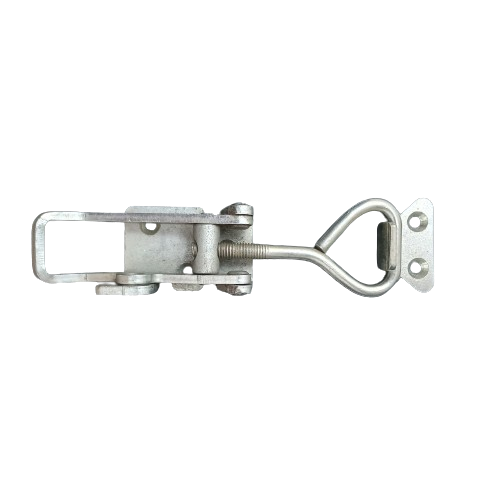

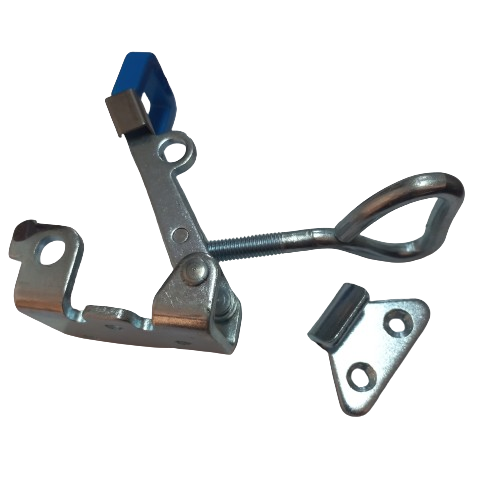


مقالات
لا تقل قيمة البحث في تاريخ الكتابة عن قيمته في أي جانب من جوانب دراسة اللغة إذ إن البحث في تاريخ الكتابة يثمر فوائد أهمها:
(أ) التعرف على بداية التفكير اللغوي للإنسان، حيث تعد الكتابة أول مظهر يكشف عن هذا التفكير ويعلن عن بدئه، إذ إنه من المعروف أن الإنسان ما رسم كلمة أو حرفًا إلا بعد تصوره للغته، وتحليله لكلامه، ووقوفه على مكونات هذا الكلام، ومن ثم عدوا مخترع الكتابة أول لغوي في التاريخ .
(ب) الكشف عن تلك الحقائق التاريخية والجغرافية والاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان على ظهر هذه الأرض عبر تاريخه الطويل منذ نقش على حوائط الكهوف أو رسم على العظام أو الحجارة أو السعف أو الجلود حتى تعرف على الأوراق والطباعة.
(ج) معرفة نظم الكتابة في العالم القديم والحديث، وإدراك ما بينها من علاقات، والإفادة من ذلك في محاولة الوصول إلى حقيقة الكتابة الأولى ومصدرها، وعقد الموازنات بين تلك النظم بغية تعلمها ومعرفة مدى إفادة بعضها من بعض.
(د) الوقوف على تاريخ الكتابة ومصدرها وأنواع نقوشها ورسومها وخطوطها.
وقد مرت الكتابة الإنسانية بأربع مراحل حتى وصلت لنا في الصور التي نستعملها الآن.
المرحلة الأولى: الكتابة التصورية
في هذه المرحلة لجأ الإنسان القديم إلى تصوير ما يريد التعبير عنه بالصور والرسوم فإذا أراد أن يدل على شجرة رسم شجرة، وإذا أراد أن يدل على حيوان رسم ذلك الحيوان.
"وتعد هذه المرحلة ـ في الواقع لونًا من ألوان الفن التصويري يمثل في صوره القديمة أرقى ما وصل إليه الإنسان القديم من قدرات فنية وملكات تعبيرية؛ ذلك أن الإنسان في عصوره الأولى بدأ التعبير عن الأشياء والمعاني بالأشياء نفسها وبالأحداث الواقعية، فهو يحطم أغصان الشجر ليدل على أن ثمة مرورًا حدث في تلك الغابة، ويجمع الرماد ليشير إلى أن هناك من استراح تحت تلك الشجرة ".
وتسمى هذه الكتابة بالبكتوغرافية pictiography وهي من أصل كلمتين picture أي صورة وgraph أي رسم أو كتابة ، وقد عاشت الكتابة التصويرية عهد طفولتها بين المجتمعات القبلية الصغيرة، وكان ذلك في العصر المسمى بالعصر الحجري القديم أو "الباليوليت.
" فقد عثر في بعض المغارات والكهوف التي ترجع إلى هذه العصر الذي يرجع تاريخه إلى فترة تتراوح بين 100 ألف سنة و40 ألف سنة تقريبًا ق.م على رسوم على بعض الصخور غير واضحة مما يدل على إنسان تلك الفترة لم يكن قد تمكن بعد من الرسم الجيد أو التصوير المتقن وربما كانت مغارة "لافيراسي" في فرنسا خير مثال على ذلك " .
وفي أواخر هذا العصر أو في القترة التي يسمونها بفترة الحضارة المادلينية التي ترجع إلى ما بين (25 ألف سنة - 15 ألف سنة ق.م) لوحظ أن التصوير الفني قد خطا خطوة مهمة إلى الأمام، فقد ترك لنا إنسان تلك الفترة على حوائط مغارات عديدة مثل مغارات "كومباريل" و "فون ـ دي ـ غوم" و "الأخوات الثلاث" في فرنسا من الصور والرسوم ما يبدو كأنه معرض فني للرسم.
وفي الفترة التالية لذلك التي تقع ما بين (15 ألف سنة و 8 آلاف سنة ق. م) التي تعرف باسم العصر الحجري المتوسط "الميزوليت" في هذه الفترة بدأت فعلا الكتابة الصورية حيث لوحظ في اللوحات التي تعود إلى ذلك العصر شيء من التعقيد، وتشعب العناصر وساد الطابع الروائي، إلا أن الآثار الراجعة إلى تلك الفترة لا تقدم للدارسين ما يمكن عده من الرسائل الاتصالية كشواهد القبور أو تدوين التواريخ أو ما يشبهها من الحوليات.
ويقرر د عبد الله ربيع أنه "قد ظهر كل هذا بوضوح فيما يعرف بالعصر الحديث " النيوليت " الذي يقع فيما بين (الألف الثامن والألف السادس ق.م) فقد دلت الحفريات التي اكتشفت على أن الكتابة الصورية قد بدأت فعلا في هذا العصر فقد ظهر هذا بوضوح فيما وصل إلى أيدي العلماء من آثار سومرية ومصرية وهندية وكريتية وصينية قديمة ".
أما رموز هذه الكتابة التصويرية فــ "يلعب شكل الإنسان، والناس، والحيوانات، والأشجار الدور الأساسي بالإضافة إلى الفن الذي ملأ الكهوف المقطونة من قبل الإنسان القديم. وقد أيدت هذه الحقيقة التنقيبات التي قام بها علماء الآثار بالإضافة إلى الحقائق الأنثوغرافية التي انكب العلماء على دراستها " .
وهكذا يبدو أن رموز هذه الكتابة "الصورية" قد استمدت من واقع الحياة التي عاشها الإنسان القديم فهي رموز تعبر عن الحوادث كالصيد والتنقل، وعن الأشياء كالقارب والمجداف، وعن الواقع كالناس والحيوانات.
وكون هذه الرموز مستمدة من واقع هؤلاء الذين استخدموها يجعل الباحث يطمئن إلى أن العلاقة بين هذه الرموز وبين ما تدل عليه هي علاقة عرفية اصطلح عليها الناس آنذاك وهذا نفسه ما يفسر العلاقة بين الرمز الكتابي وبين ما يدل عليه في كتابة الناس في يومهم هذا.
ولا تزال الكتابة الصورية تستخدم عند بعض القبائل البدائية حتى اليوم، وإن بعض الكاريكاتور في الوقت الحاضر ليرسم الصورة المفردة "بدون تعليق" فيفهم منها قصة كاملة أو يرسم نسقًا من الصور بعضها إلى جانب بعض دون أن يرشد الناس بالكتابة إلى محتويات هذه الصور، ولكن مع ذلك نفهم القصة على النحو الذي قصده الرسام، كما أن اللافتات المرورية الموجودة على جوانب الطرق والشوارع تحمل من الرسوم والعلامات الإرشادية ما يجسد هذا النوع من التعبير الكتابي.
ونظرًا لأن هذه الكتابة لم تكن واضحة المعاني، ولا ثابتة القواعد حيث كانت ترسم بأمزجة مختلفة حسبًا لظروف وقدرة الكاتب الفنية فكانت في غالب الأحيان تحمل العديد من المعاني والتفاسير تختلف من قارئ لآخر، وهذا ما يلحظ اليوم في اللوحات التشكيلية التي تفسر من قبل مشاهديها كل حسب مفهومه الخاص ورؤيته الشخصية . ونظرًا لذلك تهيأت الأسباب للشعوب آنذاك لتفكر في تطور كتابي يتلاءم مع ظروفها.
المرحلة الثانية: مرحلة الكتابة اللوغرافية أو الكلمية
نظرًا لظروف حياة الإنسان وإرضاءً لطموحه الدائب الذي يسعى إلى التطوير وتعلم المزيد جاءت هذه المرحلة وهي التي يمكن أن يقال فيها إن الإنسان توصل من خلالها إلى إرساء قواعد الكتابة التصورية، حيث أخذت اللوحات التصورية (البيكتوغرافية) تتجزأ إلى عناصر ورموز منفصلة اكتسب - بفعل استعمالها المستمر - صبغة الثبات سواء أكان ذلك في شكلها أم في معانيها، وهذا يعني أن شكلا جديدًا من أشكال الكتابة التصويرية قد استحدث سمي - فيما بعد - بالكتابة اللوغرافية، أو الكتابة الرمزية .
وتكتسب اللوغرافية أو الكلمية هذا الوصف (لوغرافية) من كلمتي logos"" بمعنى "كلمة" و"grapho" بمعنى "كتب" ومعنى ذلك أنها تعني كتابة الكلمات، وعليه فهي كتابة لغوية .
وإذا كانت هذه المرحلة تختلف عن سابقتها في تخصيص دلالة الصورة أو الرموز الكتابية فإن لنا أن نتساءل عن كيفية هذا التحول تحول الكتابة من المرحلة الصورية إلى المرحلة الكلمية؟
من الأفضل القول بأن الإنسان انتقل من التعبير عن الشيء مركبًا إلى التعبير عنه بالصورة المفردة تبعًا لحاجاته ومطالبه المتجددة ، فهو يصور كل يوم ما تتطلبه الضرورة من الصور الدالة على الكلمات معتمدًا على الجانب الواقعي المادي بالنسبة للمعاني الحسية أو الملموسة ، أما بالنسبة للتعبير عن المعنويات فإن اجتهادات كثيرة بذلت لحل هذه المشكلة ، فالمصريون القدماء - مثلا - قد اتبعوا طرقًا في ذلك منها تصوير الجزء للدلالة على الكل ، أو تصوير السبب للدلالة على المسبب ، فصورة الشمس ترمز للنهار ، وصورة أداة الكتابة تدل عليها ، وصورة الرجل تدل على العدو ، وصورة الأسد تدل على الشجاعة ، كما كانوا يعبرون في كتابتهم على المنتصر وعن المحارب أيضًا بصورة شخص في يده قوس ونشاب ، والسومريون - مثلا - يرمون لمثل هذا المدلولات بالجمع بين رمزين لكل منهما دلالة خاصة مستقلة فلتصوير "الولد" يرمز صورة "طائر" + بيضة ولتصوير "الأكل" يرمز بصورة خبز + فم.
هذا عن كيفية انتقال الكتابة من المرحلة الصورية إلى المرحلة الكلمية، أما الموطن الأصلي للكتابة الكلمية فموضع تساؤل أيضًا؟
تضاربت الأقوال في بيان الموطن الأصلي للكتابة الكلمية، ومن ذا الذي بدأ بها أولا؟ آلمصريون أم السومريون أم الصينيون أم غير هؤلاء جميعًا؟ ومن الأخذ؟ ومن المأخوذ عنه؟
تضاربت الأقوال في هذا وتنوعت تبعًا لتدفق سيل المكتشفات التي تظهرها البعثات العاملة في أرض تلك الحضارات القديمة ، وتبعًا لتلك الاجتهادات القوية في قراءة ما يصل إلى أيدي العلماء من النقوش والمسطورات ، فيذهب بعضهم إلى سبق السومريين واقتفاء المصريين آثارهم معتمدين على ما قدمته المكتشفات من نقوش سومرية تمثل مرحلة الانتقال من الكتابة التصورية إلى الكتابة الكلمية الأمر الذي لا يوجد له نظير فيما كشف لنا من آثار ذلك العهد المصري القديم ، ولكن هذا الرأي يمكن الرد عليه بأن السبب فيه ربما يرجع إلى طريقة كل من الشعبين في تدوين آثاره ، فالمادة التي كتب عليها السومريون - وتتمثل في الطين المطبوخ - أطول عمرًا من المادة التي كتب عليها المصريون والتي تتمثل في الجلود والأخشاب والبردي والتي ربما أذهبتها أحداث الزمان.
"ولعل ما ذهب إليه كثيرون من أن هذه الشعوب كلها قد اهتدت إلى هذه الوسيلة مستقلة بعضها عن بعض، ودون أن يأخذ أحدها عن الآخر في تلك الفترة من أكثر الأقوال صحة وقبولا؛ ذلك أن التاريخ لم يكشف لنا حتى الآن عن علاقات ترجح ما ذهب إليه بعضهم من سبق السومريين واقتفاء المصريين آثارهم " .
هذا وقد تطور هذا اللون الكتابي على يد كل من المصريين والسومريين نتيجة إحساسهم بما فيه من تعقيد فحاولوا تيسيره بقدر ما يمكن وتبعًا لظروفهم الفكرية والعلمية، وظهر نتيجة لذلك الخط الهيروغليفي وهو عبارة عن صور مختلفة كل صور تؤدي معنى من المعاني، هذه الصورة مكونة من رسوم الأشياء التي عرفها المصري القديم ورآها من حوله .
ولا شك أن في استخدام هذه الصور التي بلغت " أكثر من سبعمائة شكل " صعوبة على القارئ في فهم المعنى المقصود، فكان لابد من تهذيب ذلك الخط تهذيبًا تابعًا لتطور الحضارة متمشيًّا مع طبيعة النشأة والارتقاء، فنشأ لذلك عند المصريين أنفسهم بعد الخط الهيروغليفي الخط الهيراطيقي والديموطيقي .
أما الخط الهيراطيقي أو الهيراتي فهو لفظ إغريقي معناه المقدس، فقد كان صورة مختصرة للخط الهيروغليفي، واستخدم في الكتابة المقدسة وغير المقدسة، حتى حل محله الخط الديموطيقي وهو الذي كان بدوره مختصرًا للهيراتي، وقد استخدم في مصر بعد القرن السادس أو السابع ق.م، ومن أمثلة ذلك ما جاء مدونًا على حجر رشيد الذي عثر عليه أحد ضباط نابليون بونابرت 1799م في أثناء الحملة الفرنسية على مصر ، واستعان به الأثريون في معرفة الكتابة المصرية القديمة ، وأول من خطا الخطوة الأولى في حل رموز هذه الكتابة تومس بينج الإنجليزي ت1829م، ولكن الذي ينسب إليه فضل التغلب النهائي على الصعوبات في معرفة الكتابات المصرية القديمة العالم الفرنسي فرنسوا شامبليون (ت1832م) ، وقد أثبت شامبليون أن في هذه الرموز المستخدمة على حجر رشيد ما قام مقام حروف هجائية في عصر لم تكن تعرف فيه الحروف .
ونتيجة لهذا التطور أيضًا نشأ عند السومريين الخط المسماري . ومع هذا التطوير لهذا النظام الكتابي، إلا أن رموزه مازالت كثيرة مما دعا الإنسان إلى مزيد من التفكير لصقل نظامه الكتابي وهذا ما شهدته الكتابة المقطعية.
اقرأ أيضا :- مراحل نشأة الكتابة الإنسانية 3-4
01024076008